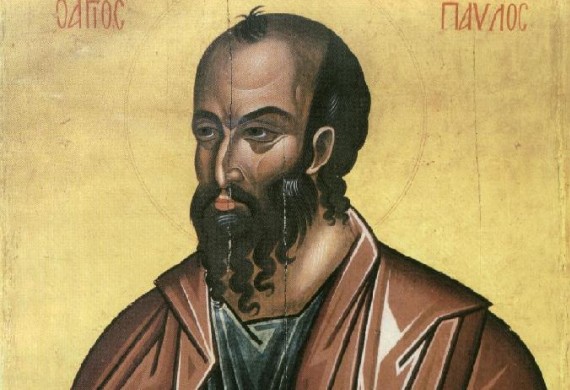ماذا أراد الرسول، في عظته البليغة المسمّاة “الرسالة إلى العبرانيّين”، بقوله إلى مؤمنين يعرفهم عن قرب: “ولنا في هذا الموضوع كلام كثير، صعب التفسير، لأنّكم كسالى عن الإصغاء” (٥: ١١).
كان الرسول يكلّمهم على المسيح “عظيم الكهنة” الذي تلقّى المجد مِمَّنْ قال له: “أنت ابني وأنا اليوم ولدتك”، و”تعلّم الطاعة، وهو الابن، بما عانى من الألم”، و”صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبديّ” (٥: ١- ١٠). ثمّ بيّن أنّ كسل المؤمنين مرضٌ، قرّروه بأنفسهم، بقوله لهم: “كان عليكم أن تستفيدوا من الزمن، فتصبحوا معلِّمين، في حين أنّكم محتاجون إلى مَنْ يعلّمكم أوّلِيَّات أقوال الله” (٥: ١٢).
أوّل ما تكشفـه هذه الكلمات أن ليـس جميــع المـؤمنيـن كانوا، في ذلك الحين، قـادريـن على القـراءة، أو يحـوزون، كما نحن اليوم، الكتاب المقدّس مجمـوعًا. معـرفتهـم تـأتي، عمـومـًا، من إصغـائهم إلى ما يُتلى عليهم في اجتماع العبـادة. وتكشف، تـاليـًا، أنّ الإصغـاء يُفتـرض أن يكـون قـبـولاً جـِدّيـًّا دائمـًا. ويجـب أن نلاحـظ، أيضًا، أنّ ما قالـه عن الكسل، في الإصغـاء، أتى به بعـد أن ذكـر طاعـة الابـن. فالمسيحـيّ، كلّ مسيحـيّ، إنّما الربّ مثـالـه في كلّ شيء. لا يقــدر مسيحـيّ على أن ينخـرط في الجمـاعـة انخـراطـًا شكليـًّا، أو أن يمشـي في إثـرِ أيٍّ كان. إن كانت الجماعة تضمّ كسالى (وربّما ستبقى تضمّهم إلى منتهى الدهر)، فهذا لا يشرّع أن نمشي في إثرهم. إن شرّعه، يغيب أنّ الربّ إيقونةُ التزامنا. ويجـب أن نلاحظ، أيضًا وأيضًا، أنّ الرسـول يـوحـي، بكلامـه، أنّ الكسـول لا يضرّ بنفسه فحسب، بل قد يشـوّه الحياة الكنسيـّة التي لا تحتمل أن يكـون أحدٌ سبـبًا لتـأخيـر بـوح “الكـلام الكثـيـر”. هل يجـب أن نشتـمّ، في كلامـه، عطـر رحمـة؟ أجل! إنّما، بعـد التـوبيـخ!
ثمّ تبدو، في قوله، مشكلة الكسالى أنّهم يتعاطون الزمان تعاطيًا غير مشروع، أي “لا يستفيـدون منه”. هل أراد أنّهم يوهمون أنفسَهم بغدٍ سيكونون فيه أفضل؟ ربّمـا! فالكسل، الـذي يتكلـّم عـليـه، كسل مقصود.
وما دام مقصودًا، فلا بدّ من أنّ له تبريـراته. وكلّ تبـريرِ خطأٍ، يشـرّع لنا أن نبقى قابعين فيه، مادّته ذلك الاطمئنان المعيـب إلى أنّنا نضمـن غدنا. وهذا غباء كامل. لا لأنّ الإنسان لا يمكن أن يضمن غده فحسب، بل إكمالَ يومـه أيضًا (لوقا ١٢: ٣٠). فالمسيحيّ الراشد هو مَنْ يحيا في اليوم دائمًا (عبرانيّين ٣: ١٣- ١٥). لكنّ الثابت، في كلامه، أنّه يوبّخ كلّ مَنْ لم يفهم منهم أنّ المسيحيّة تأبى أن يكـون فيها، إلى الأبد، طبقتـان: أنـاس يعلّمون، وآخرون يتعلّمون. وهذا يؤكّده كلامه التابع: “فتصبحـوا معلّمين”. هل هذا يعني أنّ التعليم أمر مرحليّ، أي نتعاطـاه إلى حين؟ لا، بـل يعني أنّنـا، تلاميـذ دائمًا، مسؤولـون عن حفـظ الكلمـة وَنَقْلِها. في منطق العهد الجديد، ما من عضويّـة كنسيّـة تقـوم على الاكتفـاء بمشاهدة ما يجري حولنا، أو بالإصغاء إلى ما يُحكى أمامنا. في العهد الجديد، كلّ مؤمن مسؤول عن مدّ خلاص الله في العالم. الحيـاة الكنسيـّة مواهـب، طبعـًا. لكنّ الكسالى لا يهملون مواهبهم فحسب، بل، أيضًا، يحيـون كما لو أنّهم أسيـاد ذواتهم. وهذا يشـوّه الحيـاة الكنسيـّة كلّها التي ليست فيها سيـادة سوى سيادة “أقـوال اللـه”.
إذًا، أرادهم أن يصبحـوا معلّمين. وهذا يجب أن نـراه من وجهتين لا تفتـرقـان. الأولى أنّـه يـريـدهم أن يتعـاطوا التزامهم بجدّيـّة ظاهرة، أي أن يكفّوا عن كسلهم الآن. والثانية أنّه، كبيرًا، لا يحتكـر التعليم في شخصه. لا نستطيع أن نقـرأ هذه الإرادة الطيّبـة من دون أن نغبّطـها تغبيطـًا عظيمـًا. والبراعـة، في هذه الإرادة، أنّها تُفصح أنّ الرسـول، على تـأكـّده من كسلهم، تـراه لم ييـأس منهم. كان بإمكـانه أن يقـول: “إنّكم قد أتعبتموني، ولست بمستعدٍ لأن أضيّع وقتي معكم بعدُ عبثًا. حاولت، ووصلت إلى قناعة بأنّكم لا تنفعون شيئًا. سأتركم. سأهجركم، وأمتدّ نحو سواكم. هل تعتقـدون أنّكـم الدنيـا وحدكم؟”. لكنـّه لم يقـل ذلك. لم يفعل ذلك. اعتبر، أو هذا ما يجب أن نـراه، أنّه مسؤول عنهم حتّى فيما هم كسالى. من أين أتى بهذا الإصرار؟ من إيمانه بفعل الله. يجب أن نرى بولس، بينما يقول قوله، يحملهم، وينظر إلى الله الحاضر والفـاعـل، ويـرجـوه أن يمطر عليهم نعمه المجدّدة. كلّ إنسان يمكن أن يصطلـح. هذه ليس ثقـةً بالنـاس، بل بإلـه يعـرف الرسـول أنّـه قادر على أن ينجح حيث يبدو، بشريًّا، الإخفاق كاملاً (قابل مع: لوقا ١٨: ٢٧).
أمّا السؤال الباقي، فهو: هل يمكننا أن نصغي، في كلام الرسول، إلى أنّ كسلهم نوع من رفض كلام، يعرفونه، يزعجهم أنّه يُعاد عليهم؟ هذا يعنينا أن نصغي إليه؟ فالتعليم الكنسيّ قد يعاد في لقاءات الجماعة، لا سيّما إن ضمّت جددًا أو كسالى. كيف يتلقّى المؤمن كلماتٍ يعرفها؟ بوضعه نفسَهُ تحتها دائمًا، أي، بكلام واحد، يتلقّاها كما لو أنّه يسمعها أوّل مرّة. إن تأفّف، يبدي أنّه لا يريد أن يفهم أنّ كلّ أرض، لتثمر، يجب أن تشرب “ما ينزل عليها من المطر مرارًا” (عبرانيّين ٦: ٧). ليس من مؤمن، في الأرض، يشرّع له أمر أن ينسى أنّه، أرضًا (لوقا ٨: ٤- ١٥)، مدعـوّ إلى أن يسمع الكلمـة، في غيـر وقت، بقـلب طيّب كـريـم، ويحفظها، ليثمر بثباته. فالكلمةُ تكرارُها يدعونا إلى الثبات. مَنْ يؤكّد لي، إن ألقيت عليَّ كلماتٌ أعرفها، أنّ الله لا يخاطبني، شخصيًّا، من جديد؟ مَنْ يضمن أنّه لا يراني أحتاج إلى ما يُتلى عليَّ الآن؟ أنا أرض؟ إذًا، يجب أن تكون قناعتي أنّني محتاج إلى مطر الكلمة دائمًا (أشعيا ٥٥: ١٠ و١١)!
هذا القول الرسوليّ يحثّنا على نبذ كلّ ما ينسينا أنّ قيمة حياتنا أن نكون قاماتٍ تصغي، وتشهد.