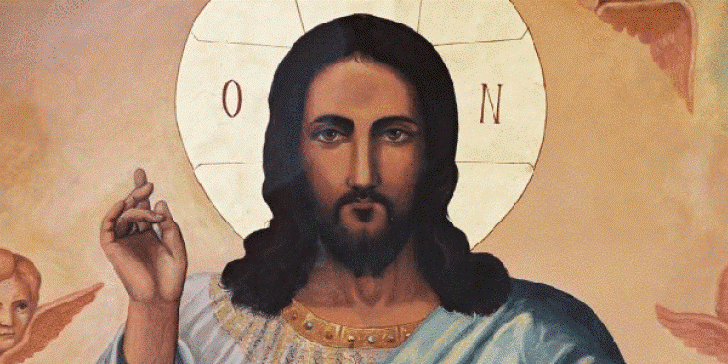رضى الله كائن بالإيمان وحده، لأنّ اللّاإيمان نكران لله وحكم بلا إمكان العلاقة بالله. الإيمان، أوّلًا، اعتراف كيانيّ، لا دماغيّ فقط، بوجود الله. والإيمان، ثانيًا، إقرار بأنّه حيّ وفاعل. والإيمان، ثالثًا، هو التّسليم بأنّ منه وبه وله كلّ شيء وبغيره ليس شيء ممّا كوِّن وممّا هو كائن. والإيمان، رابعًا، هو تأكيد إمكان العلاقة به ولزومها وإلّا لا يحقِّق أحدٌ إنسانيَّته. والإيمان، خامسًا، هو القول بحتميّة العلاقةِ محبِّيّةً في ماهيّتها وإلّا لا علاقة بالله البتّة.
لذلك الإيمان، في القناعة العميقة، هو أن تأمن لربّك، أن تُسلم له أمرك لأنّه حاضنك في المحبوبيّة، ولأنّك من دونه يتيم، ولا تستطيع شيئًا، وغبيّ مهما كنت ذكيًّا، وأن تعي أنّه القادر على كلّ شيء، ولا شيء يأتيه حيالك، أو يسمح به من نحوك، من حيث هو الضّابط الكلّ، إلّا لمنفعتك، علمتَ أم لم تعلم. رغم ذلك ليس ربّك مصدرًا لسوء يصيبك، بل محوِّل كلّ سوء لخيرك. السّوء من إبليس، وتاليًا منك إن ماشيته. هذا إن ارعويت واتّعظت. خيرُه لا يفعل فيك تلقاء. فقط إن اقتبلتَ كلامه وتعاونت وروحه يفعل فيك. بغير كلام، إنْ تُبْتَ، أي إن استجبتَ لانعطافه عليك، تَلْقَ الخيرَ يشقّ طريقه إليك. والخير ربُّك. محبّة هو. لذلك لا مسافة بينه وبين فعله. هو حضور وفعل معًا لأنّه روح!.
كيف تأتي إلى الإيمان، بالرّوح والحقّ، أي كيف تقتني نسغ حياة جديدة يسري في كيانك من حياة ربّك؟. من دونه لا يكون لك إيمان، ولكنْ، من دونك، أنت أيضًا، لا سبيل إلى سريان نعمة الإيمان من ربِّك إليك!. لذا السّؤال: كيف ينفتح كيان الإنسان على ربّه؟. كيف يستدعي ربَّه إليه؟. في الحقيقة، وحده الله هو المبادر. هو العامل على تحريك كلّ نفس إليه. به نأتي إليه، ومن دونه لا وقوف لنا لديه!. بلاه يموت الإنسان في خطيئته. يقع في اليأس. المعاناة سبيل ولكن سالب. في ذاتها، المعاناة لا تكفي. لكنّها تهيّء لله الأرضيّة المناسبة فينا. تعدّ الحطب للاشتعال. إذا كان رطبًا لا يشتعل. رَطَب النّفس، أي انغماسها في الهوى واستغراقها في دَبَق الخطيئة، عن إرادة، يحولان دون اتّقاد عمل الله وروحِه فيها. المعاناة، والألم، والضّيق يجفِّف النّفس. به تصير النّفس قابلة للنّار متى انقدحت، ولحضور الله متى تجلّى. وهو متجلٍّ في الوقت الموافق، العارف هو، وحده، به. حاضر بخفر، أبدًا، لأنّه لا يقتحم أحدًا!. الوجع يأتي كاستدعاء. الموجوع يستغيث!. “اللّهمّ بادر إلى معونتي”. فيجيبك ربّك: هأنذا إليك!.
لذلك، الشّعور بالضّعف ووخز الألم، كأنّه، بشريًّا، على غير طائل، فرصة لحركة النّفس إلى ربِّها. لكن الفرصة تضيع إذا لم نغتنمها. الهرب بكلّ أنواع المخدّرات والمتع العابرة لا ينفع. بالعكس، يلقي صاحبه في الفراغ ويزيد معاناته حدّة. ليست اللّعنة أن تتألّم بل أن لا تتعلّم، ممّا تتألّم منه، أن تعود إلى نفسك، ومن ثمّ إلى ربّك. الألم مؤشِّر علّة، والعلّة أن تحسب أنّك قادر على أن تحيا من دون الله. لأنّك نأيت عنه تعاني، حتّى في الجسد. منه، وحده، العافية. وهو، وحده، السّلام في الحقّ.
في العالم، الضّعف عيب. يخفيه النّاس بما أُوتوا. القوّة، عندهم، هي الفضيلة. أمّا الألم فلعنة!. يخوضون أقسى المعارك لإزالة الألم، أو أقلّه تخديره!. المأمول عندهم إنسان القوّة، حياة بلا ألم، وصولًا إلى بشريّة بلا موت!. استكبار ووَهْم!. الإيلام ليس من ربِّك، بل ثمرة الغرور هو!. والضّعف واقع المخلوق لأنّه مخلوق. “قوّتي من عند الرّبّ…”!. عند ربّك، وتاليًا عند مَن عرفوه، الشّعور بالضّعف مدعاة للفخر، ومجلبة، في المسيح، لقوّة الله على الإنسان. أفتخر، بالحري، بضعفي، على قولة بولس الرّسول، لكي تحلّ عليّ قوّة المسيح (2 كورنثوس 12)!. أمّا الألم – من أجله، طبعًا – فإيذان بانسكاب نعمة ربّك عليك!. أمر يتخطّى الفهم، أنّ العطاء الإلهيّ الكبير يأتي على الّذين يأتون من ألم كبير دون أن ييأسوا!. الكلام على عبد يهوه، في نبوءة إشعياء (53)، فيه ما يصدم عميقًا، أقصد القول أنّ الله سُرَّ أن يسحقه “بالحَزَن”، على حدّ تعبيره. الحَزَن هو الغمّ والكآبة، أي الألم الّذي يتخطّى وجع الجسد إلى وجع النّفس!. بشريًّا، القول بمسرّة الله بأمر كهذا، معثرة هائلة!. لكن المنطق، هنا، إلهيّ بحت!. حكمة الله، إثر السّقوط، أنّ حوّاء بالوجع تلد الحياة. هذا شأن البشريّة، أيضًا، في حملها الحياة الجديدة!. بمقدار ما نجمت عن الخطيئة الجدّيّة متعةٌ في أكل التّفّاحة، حتّى الثّمالة والموت، بالمقدار عينه، لا تنجم نعمة الحياة الجديدة إلّا عن الألم، في الرّجاء، حتّى الموت!. هذا مضمون صليب المسيح، هذا هو الإفراغ الإراديّ الكامل للذّات!. بهذا الإفراغ، بالذّات، التحم السّيّد بالبشريّة، من طريق التحامه بمعاناة كلّ إنسان، لأنّ المعاناة، في عمقها، في الكيان، واحدة!. هذا يجعل، بمعنى، أنّ ربّك قبل أن ينعم عليك بالعطاء الكبير، الّذي هو إيّاه، ذاتُه، ينعم عليك بالألم الكبير!. المعاناة الّتي تجعلك تتخطّى المعاناة!. وطئ الموت بالموت!. احفظ ذهنك في الجحيم ولا تيأس!. هكذا تكلّم ربُّك عن عبد يهوه، وبالامتداد عن عبيد يهوه، أنّه “إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلًا تطول أيّامُه، ومسرّة الرّبّ بيده تنجح”!. هذا خصب الصّليب، خصب الموت في المسيح!. هذا للعالمين كلامُ جهل وقولُ عثرةٍ، لكنّه عند ربّك حكمةٌ سفّهَ بها حكمة هذا الدّهر، المتمرِّغ في حمأة المعصية!.
على هذا، التّذمّر لا يجدي نفعًا ولا الكفر!. ثمّة واقع مرير وثمّة تدبير إلهيّ!. الضّعف والألم مساحتان لِتَسقُّط البَركة!. وربّك، حين لا يشاء الإنسانُ أن يفهم وأن ينتفع، له في أحكامه مداخل إلى النّفس لا يعي كنهَها إلّا الّذين يختبرونها. ليس شيء منك وإليك إلّا إصبع ربّك فيه التماسَ خلاصِك. ثمّة قراءة إلهيّة لما يجري وأخرى دهريّة. لا حياد ولا صدفة!. ما لا تفهمه لا يعني أنّه غير موجود!. وما كلّ شيء برسم الفهم. عند ربّك أن تقبل!. بالإيمان لا بالعيان!. الإيمان يتخطّى الأفهام!. المسير بالقلب!. لذا العقل، لدى المؤمن، يخضع للقلب، والقلب، بالإيمان، يستسير!. حيّ هو الله الّذي أنا واقف أمامه!. هو النّور!. وبالإيمان تقيم في النّور!. لا يكبر، في النّور، إلّا مَن جعل نفسه، طفلًا، يُسلم نفسه لحضانة النّور!. إن لم ترجعوا وتصيروا كالأطفال فلن تدخلوا ملكوت السّموات!. لا يفهم الطّفل بالضّرورة، لكنّه ينعم بدفء المحبّة!. لا أترككم يتامى!. هأنذا معكم كلّ الأيّام إلى منتهى الدّهر!. هكذا كلّ مَن سلك بالإيمان!. شعرة من رؤوسكم لا تسقط إلّا بإذن أبيكم السّماويّ!. إن كان الله معنا فمَن علينا؟. فآراكم وتطمئن قلوبكم!. الجحيم أن تكون وحيدًا، ولو في الجنّة، والجنّة أن تعي، في الكيان، أنّ الله معنا، ولو في الجحيم!. لذا، ليس ما يحدث لنا، في هذا الدّهر، هو ما يحدّد المصير، بل كيف نتعاطاه؟. بأيّ روح؟. نحن أبناء الملكوت. فيه ننمو وإليه. لا نبحث عن فردوس هنا. لا نبحث عن راحة ولا عن إقامة باقية ههنا. ملكوت السّموات في داخلكم. بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السّموات!. أما قرأتم: “أيّها الأحبّاء. لا تستغربوا البلوى المحرقة الّتي بينكم حادثة لأجل امتحانكم، كأنّه أصابكم أمر غريب…” (1 بطرس 4)!. سلام العالم غير سلام المسيح!. سلام العالم خطِر عليكم. تهتاج فيه أهواؤكم عليكم، فتوجَدون محبِّين للعالم. لكن محبّة العالم عداوة لله. لذا سلام العالم تجربة لكم. آخرته خسران المسيح وعبادة ضدّ المسيح، باسم المسيح. عندما تطلبون في عبادتكم “من أجل سلام كلّ العالم”، فأنتم، في الحقيقة، لا تطلبون سلام العالم، بل سلام المسيح للعالم، لأنّ المسيح وحده سلامنا!. لماذا صار هناك رهبان في القرن الرّابع للميلاد؟. بسبب سلام قسطنطين!. يومذاك انفتح سلام العالم على الكنيسة!. التّجربة كانت أن يصير المؤمنون، كيانيًّا لا وضعيًّا، مواطنين في ملكوت هذا الدّهر، ومن ثمّ أن يتخلّوا عن مواطنيّتهم الحقّ لملكوت السّموات!. لذا آثر بعض ذوي الحسّ الإلهيّ المرهف أن يخرجوا إلى الصّحراء، إلى أرض المعركة الكيانيّة الّتي لا مناص من خوضها، “فإنّ مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرّؤساء، مع السّلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدّهر، مع أجناد الشّرّ الرّوحيّة في السّماويّات” (أفسس 6)!. سلام العالم ملتبس، ظاهره لا حرب وباطنه استسلام لأجناد الشّرّ الرّوحيّة!. يستحليه المرء لأنّه من طبيعة الإنسان العتيق فينا، لذلك يقع، بيسر، كمؤمن، في تجربة اقتباله واعتباره، زورًا، بركةً من عند الله!. هذا حكم على الأمور بحسب الظّاهر!. المهمّ المعاينة لا بالعين المجرّدة بل بالرّوح والحقّ!.
سلام المسيح شيء آخر. هو المسيح فينا. سيّان في أيّة وضعيّة بشريّة نكون. المؤمن يدرك، في أعماقه، أنّه طالما هو ههنا، في الجسد، فإنّه في حالة حرب مع نفسه، مع أهوائه، ومن خلالها ضدّ مكايد إبليس، على حدّ تعبير الرّسول بولس (أفسس 6)!. وهذه الحرب لا تضع أوزارها إلّا بالنّصرة على أهواء النّفس والتّسليم الكامل لله!. “سأقتفي أعدائي حتّى أدركهم ولا أرجعنّ حتّى أفنيهم” (مزمور).
في يديك أستودع روحي!. إذ ذاك يصير لنا سلام حقّ!. لذا سلام العالم ليس من الله ولو سمح به الله!. السّلام والحرب في هذا العالم نقرأهما قراءة روحيّة، مهما كان هذا صعبًا علينا، بشريًّا!. المهمّ أن تكون لنا في الحالين معًا منفعة روحيّة، حتّى لا يستحيل الإيمان بيننا صوريًّا والكنيسة نفسانيّة والمسيح صنميًّا!. الله روح وبالرّوح والحقّ ينبغي أن تسجدوا!.
أما قال ربّنا: أنتم لستم من هذا العالم، بل أنا اخترتكم من العالم؟. فإن فكّرنا كما يفكّر أهل هذا العالم، وسلكنا كما يسلكون، رتعنا في الكفر، لأنّه أيّة شركة للبرّ والإثم، وأيّة شركة للنّور مع الظّلمة. لذلك اخرجوا من وسطهم، في الفكر والمسرى، معًا، واعتزلوا، ولا تمسّوا نجسًا فأقبلكم وأكون لكم أبًا، وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرّبّ القادر على كلّ شيء!.
الأرشمندريت توما (بيطار)، رئيس دير القدّيس سلوان الآثوسيّ، دوما – لبنان
عن “نقاط على الحروف، 23 تشرين الأول 2016